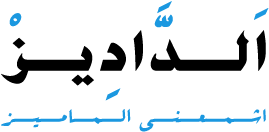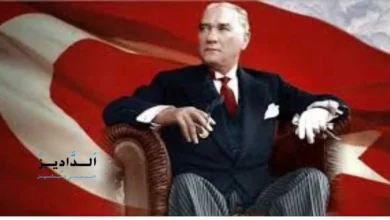سقوط الدولة الإخشيدية ورحيل محمد طغج الإخشيدى

لمن يتابعنا للمرة الأولى، تحدثنا في سلسلة مقالات مميزة عن الحضارة المصرية من بدايتها بشكل مفصل حتى وصلنا إلى الفتح الفاطمي وسقوط الدولة الإخشيدية وللحديث بقية.
منذ بداية العالم وضُخ دم البشرية في عروق الحياة، خرجت للدنيا حضارة تعد عالما قائما بذاته، غيرت مجرى التاريخ ورسمت ملامح عظمتها على وجه الزمن، وكنا وما زلنا وسنظل نفخر بها حتى النهاية، ودائما نأخذ دور غواص في بحر الحضارة المصرية القديمة ونفتش عن الحضارة المصرية ونسرد ومضات تاريخية عن تاريخ الاسر المصرية القديمة.
فتحدثنا عن ومضات تاريخية للحضارة المصرية منذ البداية أي قبل أن يحفر المصري القديم مكانته بين البشر، وينطلق لأعنان السماء معلنا عن بداية ليس لها نهاية، من عبقرية وتحدٍ وقدرة على الإبداع لم يعرف لها العالم سر بعد، وقررنا أن ننزل إلى الأعماق.
تحدثنا في المقال السابق عن الفتح الفاطمي لمصر وسقوط الدولة الإخشيدية واليوم نستكمل الحديث عن هذه الفترة من تاريخ الحضارة المصرية.
تحدثنا في المقال السابق عن الفتح الفاطمي لمصر وسقوط الدولة الاخشيدية -وما زلنا نتحدث عن هذه الفترة-، وتناولنا التجارة والصناعة والاقتصاد في هذه الفترة بصفة عامة. اليوم نستكمل الحديث عن تأثير هذه الحقبة على تاريخ مصر وأسباب سقوط الدولة الإخشيدية، ونستكمل تفاصيل هذا العصر في مصر ونبدأ بالأوضاع الاجتماعية.

الأوضاع الإجتماعية
كان لشكل المجتمع صدى كبير وبداية لـ سقوط الدولة الإخشيدية؛ حيث انقسم الناسُ في العهد الإخشيدي بحسب الثروة إلى فئتين: فئة غنيَّة وفئة فقيرة. وضمَّت الفئة الأولى أفراد الأُسرة الإِخشيديَّة، وبعض التُجَّار الأغنياء والمُلَّاك، وطبقة الأشراف من العبَّاسيين والطالبيِّين والعلويين، الذين كان لهم نصيبٌ في المُدن الكُبرى. وقد عاشت هذه الفئة عيشة كُلها إسراف في الطعام والشراب واللباس، يرتدون الفراء الفاخرة ويتطيَّبون بِالعنبر.
وكانت مجالسهم حافلة بالمُغنين والمُغنيات والجواري الحِسان. وكانوا يُبالغون في الإسراف في حفلاتهم، فينثُرون النُقود على الحاضرين، وكانوا يقومون برياضة الصيد وسباق الخيل، ويجمعون الخُيول العربيَّة الأصيلة المُدرَّبة. وكان يُحيط بِأفراد هذه الفئة عددٌ كبيرٌ من المماليك والغلمان والأتباع، كما كان لهم حُجَّاب يحجبونهم عن الناس، وحُرَّاس لحمايتهم.
وأكثر ما يشير إلى ترف هذه الطبقة مواكبهم التي كانوا يسيرون فيها. فقد كان الإِخشيد يسير وبين يديه خمسمئة غُلام بالدبابيس، وبين يديه الشمع والمشاعل. أمَّا فئة العامَّة، فلا يكادُ يُسمع عنها شيء. ويبدو أنها كانت تعيش على هامش الحياة، تقبل بما يصل إليها.
وكانت هناك صلة بين الفئتين تتمثل فيما يصل من إنعام الفئة الغنيَّة إلى الفئة الأُخرى. فقد كانت كثرة منهم تغدق الخير والإحسان على الفُقراء والمحتاجين. وكان لمُحمَّد بن علي الماذرائي ديوانٌ كبيرٌ يُشرف على نحو ستين ألف مُحتاج تجري عليهم الأرزاق.
إنجازات الدولة الإخشيدية
العمارة
تذكر المصادر أنَّ مُحمَّد بن طُغج كان شديد الاهتمام بِتجديد بناء كثير من المساجد، وهو ما سار عليه خُلفاءه من بعده. فقد أنفق الإِخشيديون بسخاء على المساجد من أجل فرشها وإِنارتها، فبنى أبو الحسن علي بن الإِخشيد مسجدًا في الجيزة، وبنى كافور مسجد الفقاعي في سفح جبل المُقطَّم وكان في وسطه محرابٌ من الطوب، وهو أول محراب بُني في مصر، وبنى الوزير جعفر بن الفُرات مسجد موسى في المنطقة نفسها.
وإلى جانب المساجد اهتمَّ الإخشيديُّون ببناء وتشييد القُصُور، وعلى رأسها قصر المُختار وقصر البُستان من تشييد الإِخشيد، والبُستان الكافوري ودار الفيل من تشييد كافور. كما اهتموا بِالأبنية العامَّة، فقد أنشأ مُحمَّد بن طُغج قيساريَّات كثيرة، أشهرها قيسارية لبيع المنسوجات، كان دخلها يُحبس على البيمارستان الأسفل.
وبنى كافور بيمارستانًا سنة 346هـ المُوافقة لِسنة 957م، وأنشأ الوزير جعفر بن الفُرات سبع سقايات لسُكَّان الفسطاط لِجلب الماء من منطقة جزيرة الروضة. وعلى الرُغم من الاهتمام بِهذا الجانب من التشييد والبناء، إلَّا أنَّ الإخشيديين لم يهتموا بِبناء مدينة جديدة في مصر ترتبط بهم على غرار مدينة الفسطاط التي أسَّسها المُسلمون يوم فتحوا مصر بِقيادة الصحابي عمرو بن العاص، والعسكر التي أسسها الوالي صالح بن علي العبَّاسي، والقطائع التي أسَّسها أحمد بن طولون.
وازدادت الشجارات في مجالسه هذه ما سهل سقوط الدولة الإخشيدية، وقد وصَف ابن سعيد المغربي مجلس الإخشيد بقوله: «وكان يَصُونه أنْ يجري فيه لغطٌ أو قبيح، ولقد تنازَع أبو بكر بن الحدَّاد الفقيه، وأبو الذكر القاضي المالكي، وعبد الله بن الوليد، وجرى بينهم لغطٌ كثير، فلمَّا انصرَفُوا قال: “يجري هذا في مجلسي! كدت والله أنْ آمُر بأخْذ عَمائمهم”».
وقد اعتنى خُلَفاء الإخْشيد بتلك المجالس، واهتمُّوا بها، فقد عُنِيَ بها ابنُه أُنوجور، كذلك اعتنى بها كافور، وكان يُدنِي الشُعراء ويُجزيهم، وكانت تُقرَأ عنده في كلِّ ليلةٍ السير وأخبار الدولة الأُمويَّة والعبَّاسيَّة، وكان كافور له نظَر في اللُغة العربيَّة والأدب، وكان يحرص على أنْ يكون بلاطُه مجمع العلماء والأدباء، وأنْ يَفُوق في هذا الميدان بلاط الخليفة العبَّاسي وسيف الدولة الحمداني.

العلوم والاداب
إلى جانب العُلوم، ازدهر الأدب في مصر في العصر الإخشيدي، لكن يُلاحظ أن حظ النثر كان أوفر من حظ الشعر، وأن الشعر كانت فيه المسحة العراقيَّة والميل إلى السجع والمُزاوجة مع إطناب في اللفظ وتكرار المعنى وإقبال على الجُمل القصيرة، وكان فارس حلبة النثر الفني في العصر الإخشيدي إبراهيم بن عبد الله بن مُحمَّد النجيرمي، وممن برز من أبناء مصر في الأدب في العصر الإخشيدي سيبويه المصري وهو أبو بكر مُحمَّد بن موسى بن عبدُ العزيز الكِندي الصيرفي.
أمَّا الشعر في العهد الإخشيدي فكان هزيلًا نحيلًا ولم يكن هُناك إلَّا قلَّة من الشعراء المصريين من يصل إلى مكانة شُعراء العراق أمثال: أبي تمَّام والبُحتُري وابن الرومي، ومن شُعراء مصر في هذا العصر أحمد بن مُحمَّد بن إسماعيل بن القاسم بن إبراهيم بن طباطبا، والقاسم بن أحمد الرسي، وسعيد قاضي البقر، وغيرهم.
وقد زار مصر في العهد الإخشيدي بعض الشُعراء المشهورين منهم أبو الطيِّب المُتنبي، فأقام بها أربع سنوات عند كافور الإخشيدي يمدحه بغرض الحصول على منصب هام ولكنه لم ينل بغيته؛ فانقلب على كافور يهجوه هجاءً قاسيًا. وممَّا قاله المُتنبي في مدح كافور:
قواصدُ كافور توارك غيرهُ
ومن قصد البحر استقلَّ السواقيا
فجاءت بنا إنسان عين زمانهُ
وخلَّت بياضًا خلفها ومآقيا
ولمَّا لم يُحقق المُتنبي ما كان يطمع فيه من مناصب؛ نظم قصيدته الدالية المشهورة التي هجا فيها كافور، ومما قاله فيها مُستهزءًا بِأُصول كافور الحبشيَّة، مُذكرًا إيَّاه بِأصله كمملوك:
لا تشترِ العبد إلَّا والعصا معهُ
إنَّ العبيـد لأنجـاسٌ منـاكيـد
من علَّم الأسود المخصيُّ مكرمةً
أقومهِ البيضُ أم آبـاؤه الصيدُ؟
المُؤرخون في العصر الإخشيدي
أمَّا المُؤرخون في العصر الإخشيدي فكان لهم شأن عظيم منهم الحسن بن القاسم بن جعفر بن دحية أبو علي الدمشقي، والحسن بن إبراهيم بن زولاق ممَّن اهتموا بِتدوين تاريخ مصر وخططها ومن مؤلفاته: كتاب «فضائل مصر»، و«سيرة مُحمَّد بن طغج الإخشيد»، و«أخبار سيبويه المصري»، وغيرها من المُصنَّفات.
وكذلك البطريرك سعيد بن البطريق الذي مارس الطب أيضًا فترة من الزمن بالفسطاط، وألَّف كتابه المشهور «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» تناول فيه التاريخ منذ بدء الخليقة إلى العصر الذي عاش فيه. ومن الأطبَّاء الذين ظهروا في العهد الإخشيدي أيضًا: نسطاس بن جُريج صاحب كتاب «رسالة إلى يزيد بن رومان النصراني الأندلُسي في البول»، والبالسي الذي كان مُتميزًا في معرفة الأدوية المُفردة وأفعالها.
وله من الكُتب كتاب «التكميل في الأدوية المُفردة»، وأبو عبد اللّه مُحمَّد بن أحمد بن سعيد التميمي المقدسي العالم بالنبات وماهياته والكلام فيه، وكان مُتميزًا أيضًا في أعمال الطب والاطلاع على دقائقها، وله خبرة فاضلة في تركيب المعاجين والأدوية المُفردة.

الجيش
استطاع مُحمَّد بن طُغج أن يدخل مصر ويقضي على المُتمردين بِفضل القُوَّة العسكريَّة التي شكَّلها، واستمرَّ بعد سيطرته على مصر في زيادة عدد قُوَّاته البريَّة والبحريَّة حتَّى أضحى أربعمائة ألف، وقد تألَّفوا من عرقيَّاتٍ عديدةٍ: تُرك وزُنج وبربر، وشكَّل فرقة مماليك خاصَّة لِحراسته.
والرَّاجح أنَّ هذا الرقم مُبالغ فيه لِأنَّهُ لا يتناسب مع عدد سُكَّان البلاد في ذلك الوقت ولا مع القُوَّة الضروريَّة لِلدفاع عنها بِالإضافة إلى صُعوبة تموينه وتدبير الثكنات لِإيوائه، إلَّا أنَّهُ كان من أعظم جُيُوش عصره، بِدليل أنَّهُ عندما استدعاه الخليفة المُتقي لِله واقترب من مدينتيّ الرَّقَّة والرافقة المُجاورة لها، أشرف سُكَّانها على النوافذ والأسوار لِيُشاهدوا عِظم العسكر وحُسن عدَّته.
وأدَّى هذا الجيش دورًا هامًا مكَّن الإخشيديين من تدعيم حُكمهم في مصر والشَّام وصدّ الأخطار التي هدَّدتهم في الشَّام وثُغورها، وبِخاصَّةً هجمات مُحمَّد بن رائق وسيف الدولة الحمداني. وكان مُحمَّد بن طُغج يخرج على رأس الجيش في مُعظم الأحيان، لِلقتال، وأناب عنه القائد عُمران بن فارس لِقتال مُحمَّد بن رائق في الشَّام، كما أناب عليّ بن مُحمَّد بن كلا.
وبعد مقتل هذا الأخير، عيَّن فاتكًا وكافورًا على رأس الجيش الذي أرسله إلى الشَّام في سنة 333هـ المُوافقة لِسنتيّ 944 – 945م، وكان يُرسل إخوته في بعض الأحيان. واهتمَّ مُحمَّد بن طُغج بِبناء الأُسطول، فنقل دار صناعة السُفن من جزيرة الروضة إلى دار خديجة بنت الفتح بن خاقان، زوجة أحمد بن طولون.
كانت هذه الدار بِساحل الفسطاط، وذلك في سنة 325هـ المُوافقة لِسنة 937م بعد أن أحرق المُتمردون أُسطوله من دون أن يتمكَّن من التصدي لهم أو يقوم بِعملٍ حاسمٍ ضدَّهم، وقال في ذلك: «دارُ صناعةً يحُولُ بينها وبين صاحبها الماء ليست بِشيء». ويبدو أنَّ نقل دار الصناعة لم يقضِ تمامًا على الصناعة في دار الروضة إذ كانت مراكب الأُسطول مع ذلك تنشأ في الجزيرة وفي صناعتها.
بعد وفاة كافور الإخشيدي في جمادى الأولى سنة 357هـ / أبريل 968م عمت الفوضى والاضطرابات معظم أنحاء مصر، وتدهورت أحوالها الاقتصادية، فأصابها القحط والوباء والغلاء الشديد الناجم عن نقص فيضان النيل، وهاجم القرامطة بلاد الشام وامتد نفوذهم إليها.
في الوقت الذي عجزت فيه الخلافة العباسية عن إعادة الأمور إلى نصابها في مصر، ولذلك اتصل المصريون بالفاطميين في بلاد المغرب بعد سقوط الدولة الإخشيدية، ودعوهم للحضور إلى مصر رغبة في التخلص من الأحوال السيئة التي تردوا فيها، وساعدوهم على فتحها وإسقاط الدولة الإخشيدية.

أسباب سقوط الدولة الإخشيدية
من أسباب سقوط الدولة الإخشيدية: حدوث الخلافات الداخلية بين أفراد الأسرة الإخشيدية على الحكم وخلافات قادة الجند مما أدى إلى القيام بأمور التجنيد. بالإضافة إلى حدوث اضطرابات وفوضى في أرجاء مصر عند وفاة كافور الإخشيدي في شهر نيسان عام 968م، كما أدى ذلك إلى بِدْء اقتصاد الدولة بالانهيار.
علاوة على حدوث ثورة في طرابلس الشام سنة 968م ضدّ الإخشيديين والّذي شجع الإمبراطور البيزنطي نقفور فوقاس الثاني على دخولها والسيطرة عليها. وطلب أهل مصر من الفاطميين في دولة المغرب القدوم إلى مصر وتخليصهم من الدولة الإخشيديَّة.
كان لارتفاعِ الأسعار وفقدان الحبوب والأقوات دور كبير في تدهور الوضع الاقتصادي ومن ثم سقوط الدولة الإخشيدية، وأدت هذه الأوضاع إلى إلى ارتفاع الضرائب. فضلا عن حدوث وباء كبير هلكَ بسببه عدد كبير من الناس فكثُرَ الفساد.
هذا، وأصابَ الدولة الإخشيدية القحط والغلاء الشديد الناجم عن نقص فيضان النيل. وبدأ من هنا سقوط الدولة الإخشيدية، فقد هاجم القرامطة بلاد الشام وامتد نفوذهم إليها، فعجزت الدولة الإخشيدية وفقدت السيطرة على الأوضاع. كما أساء الحسن بن عبيد الله الإخشيدي معاملة السكان والأعيان فقام بسجن عدد من كبار الأعيان في الدولة وقام بمصادرة أموالهم.
انتهينا من سرد تفاصيل سقوط الدولة الإخشيدية والأسباب وراء ذلك، في المقال القادم سنتحدث عن الدولة الفاطمية في مصر، ونتعرف سويا على ملامح هذه الفترة من تاريخ مصر وحضارتها الباقية الخالدة. دمتم في أمان الله.